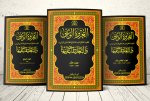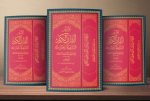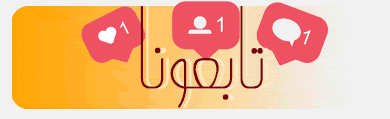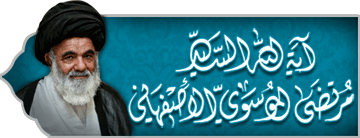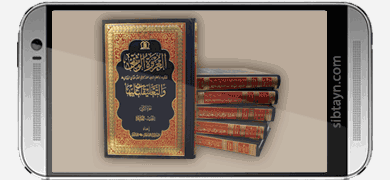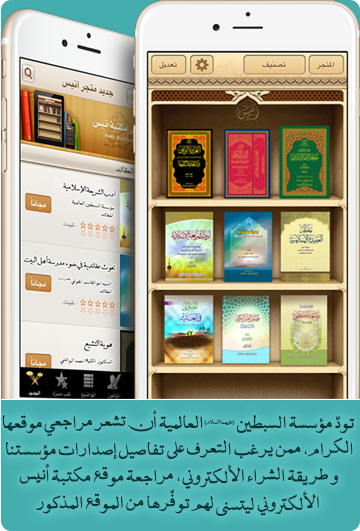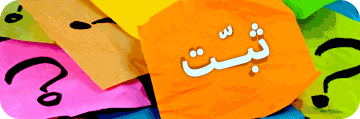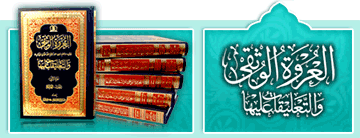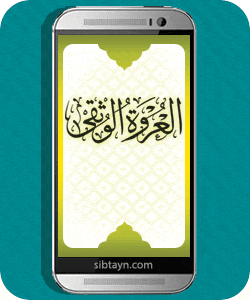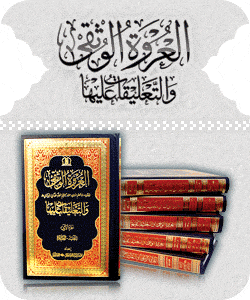الإمامة والنصّ مقدمة
الإمامة والنصّ مقدمة نقطة الخلاف عند تناول الإمامة في المدرستين
العلاقة بين العصمة والنصّ
نظرية النصّ ومبدأ الشورى
الإمامة والنصّ مقدمة
خلق الله الإنسان بطبيعة وتصميم وقابلية تؤهله لأن يؤدي دور الخلافة الإلهية في الأرض ولا يمكن لأي مخلوق آخر أن يقوم بهذا الدور حتى الملائكة لأنها قد اُمرت بالسجود له، والى جانب ذلك يمتلك الإنسان بعداً يحول دون رقيه وتطوره وكماله.
وهذا الإنسان بطاقاته السامية من جهة، ونزوعه نحو الانحطاط من جهة اُخرى، يكشف عن كونه المخلوق الوحيد الذي يمتلك الإرادة والحرية في أن يختار الفعل الأقوى والخطوة المناسبة لبناء حياته الرغيدة.
ولمّا اُعطي هذا الإنسان تلك القابلية التي منحته الحركة في مساحات وأبعاد أوسع بحيث تخترق المحسوس وتكشف أيضاً بأن لوجوده هدفاً قد خطّته يد القدرة، فلم يخلق عبثاً ولم يترك هملاً كما نصّ على ذلك الذكر الحكيم، حيث قال: (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وانّكم إلينا لا ترجعون) [1] .
وليس الإنسان وحده هو يتحرك في هذا الوجود ضمن هدف ومخطط مدروس، وإنّما تشاركه المخلوقات الاُخرى في هذه الجهة أيضاً، حتى صرّح النص القرآني بأنه: (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين) [2] .
فإذا ثبت أن الخلق كله يسير بحكمة وتدبير بما فيه الإنسان والكل سائر نحو هدف منشود وأن لكل شيء هداه فما هو يا ترى بالتحديد الهدف الذي خلق من أجله الإنسان؟
يحدد القرآن الكريم الغاية التي خلق الإنسان من أجلها بقوله تعالى: (وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون) [3] .
فهنا نلاحظ أداة الحصر (إلاّ) التي تعني أنه ليس لله غرض ولا هدف من خلق الإنسان إلاّ العبادة. واللام في (ليعبدون) لام التعليل، فالإنسان مخلوق لعلة العبادة ليس إلاّ.
فإذا كانت الغاية من خلق الإنسان محصورة في العبادة لا غير فما هي العبادة ؟ وماهي حقيقتها؟
فإذا كان الهدف والغاية النهائية من خلق الانسان هو القرب من الله وعبوديته التي يتكامل بها الإنسان فما هو المحفز والدافع الذي يضمن للإنسان وصوله لغايته وكماله؟
إنّ الإنسان بطبيعته وفطرته يدرك حاجاته التي عن طريقها يستطيع أن يسدّ النقص الحاصل في محتواه، كما أنه يدرك حاجته الى الوسائل التي توصله الى كماله فيسعى لطلبها، ولكنه كيف يهتدي الى كماله؟
من هنا نجد الحكمة الإلهية اقتضت أن تضع بين يدي هذا الإنسان تلك الوسائل والمصاديق التي يحصل بواسطتها على المعارف والقيم والتربية التي تأخذ بيده نحو الكمال.
ولما كانت مدركات البشر وحدها عاجزة على أن تأخذ هذا الإنسان وتهديه الى سواء السبيل، حتى لو تعاضد مع أخيه الإنسان لأن أقصى ما يمتلكه البشر هو التعاون بحدود مجالي العقل والحس، وهذان المجالان غير كافيين لإدراك الحقائق الموجبة للكمال.
من هنا امتدت يد الغيب لتسدد حاجة الإنسان هذه وهي أهم الحاجات، فكان الإنسان الأول نبيّاً مبعوثاً من الله الهادي الى سواء السبيل.
ومهمة الأنبياء مع الناس هي تبيان المعارف والقيم والحقائق الموصلة الى الكمال والتربية الصحيحة عليها.
وتقوم النبوة بإيضاح المعلومات التي يمكن للبشر أن يدركها وهو بحاجة اليها، إلاّ أنه قد لا يتوصل الى حقيقتها بفعل التربية الفاسدة، أو أن هذه المعلومات تحتاج الى تجارب طويلة لكي يكتشفها الإنسان مثل السنن الإلهية التي من شأنها أن تفتك بحياة الإنسان، أو السنن الإلهية التي فيما لو اختارها الإنسان سوف تؤدي الى سعادته وكماله، لكنه ينصرف عنها بفعل نزوعه نحو الماديات.
فيبرز هنا دور النبي ليذكّر وينذر، قال تعالى: (فذكّر إنّما أنت مذكّر) [4] .
كما يتجلى دور النبي أيضاً وضرورة وجوده باعتباره يمثل القدوة في العمل الصالح، لأنه الإنسان الكامل في سلوكه وأخلاقه وتضحياته، وهذا ما يسمى بدور التزكية، قال تعالى: (ويزكّيهم ويُعلّمهم الكتاب والحكمة...) [5] .
فإذا كان الهدف من خلق الإنسان هو العبودية المطلقة له سبحانه، والإنسان بطبيعته مجبول على التعلّق بالوسيلة التي تكفل له الوصول الى الكمال لأنه يجنح الى الكمال وحبه بشكل فطري، ودور النبوة هو إيضاح معالم الطريق وتبيان المعارف الحقة التي تؤدي به الى الكمال، فما هو الداعي لامتداد الرسالة من خلال الإمامة التي تشترط فيها الشيعة النص والعلم الموهوب من الله والعصمة؟
الإجابة على هذا السؤال وغيره من التساؤلات تدعونا الى أن نتساءل، ماهي الإمامة في المنظور الإلهي ؟ وماهي مهمتها؟
وبعد أن يتحرر محل النزاع، يمكن أن نجيب على الإشكالات التي ترد الى الذهن حول الإمامة وشروطها من العلم والعصمة وغيرها من الشروط اللازمة في الإمام.
نقطة الخلاف عند تناول الإمامة في المدرستين
الإمامة والخلافة في المدرسة السنّية اتجهت نحو محور واحد تركّز في أن الإمام والخليفة بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) يعني هو القائد والزعيم السياسي الذي يتولى إدارة شؤون النظام الإسلامي بعد وفاة النبي(صلى الله عليه وآله).
وعلى هذا الأساس لا ترى هذه المدرسة داعياً لأن يكون هذا القائد بنص وتعيين من قبل الله وبيان الرسول(صلى الله عليه وآله)بل الأمر متروك للاُمة حيث تنصّب من تختاره وتجده أهلاً للقيام بهذه المهمة، لأن دور الإمام والخليفة في نظر هذه المدرسة لا يتعدّى مهمة القيادة السياسية وزعامة الاُمة في هذه الحدود، فمن المنطقي أن تكون الطريقة لنصب الخليفة إما وفق نظرية الشورى، أو أهل الحل والعقد أو بالوراثة.
بقي أن نعرف ماهي الشروط التي لابد من توفرها في هذا الشخص المرشّح للخلافة السياسية بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) ؟
إنّ الشروط التي لابد أن تتوفر في الخليفة المنتخب يمكن التوصل إليها انطلاقاً من نفس الرؤية التي ترى الإمامة والخلافة بعد الرسول زعامة وقيادة سياسية فحسب، وعليه فيكفي أن تتوفر العدالة في هذا الإنسان من الناحية السلوكية بالمعنى المتداول مع شرط العلمية المتعارفة، ولا يشترط فيه العصمة والعلم الممنوح، فيكفي إذاً أن تتوفّر فيه قدرة ترفعه الى مستوى أداء المسؤوليات في النظام الإسلامي.
ومحصل رأي المدرسة السنيّة في الإمامة والخلافة هو أنها لا تتعدى كونها قيادة سياسية، وأن شرعية التصدّي لها يتم عن طريق الانتخاب والشورى، أو الاستيلاء بالقوة أو الوراثة أو الوصية، كما هو واضح من تطبيقاتها العملية المضطربة بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) ـ وشرطها العدالة والعلم بالمعنى المتعارف.
ولهذا ذهب البعض يتساءل عن ضرورة وجود إمام غائب، أو ضرورة أن يكون معصوماً، أو ضرورة تعيينه بنص الرسول(صلى الله عليه وآله).
أما المدرسة الشيعية فقد اتجهت في تقويم الإمامة والخلافة بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) الى أنها مهمة إلهية كمهمة الرسول ومستمرة حتى نهاية الأرض، فاشترطت العصمة فيها حتى قبل البلوغ، بالإضافة للعلم غير المكتسب، والنص الذي يمثل القيمة الشرعية للإمام.
ولهذا كانت المدرسة السنّيّة لا ترى لهذه الشروط ـ التي لابد من توفرها في الإمام والخليفة ـ معنى، لا تنسجم مع المسؤولية التي يتكفّل بأدائها الخليفة، فالشروط هنا أوسع وأضخم من مهمة الزعامة السياسية.
هذه هي العقدة ونقطة الخلاف التي تفسر لنا الاضطراب في فهم الإمامة والتشكيك في مسألة العصمة، أو المسوّغ لضرورة النص.
وهذا الفهم دفع بالبعض الى أن يحقق في جذور نظرية النص لينتهي بالنتيجة الى عدم وجود واقع تاريخي في حياة الأئمة لها.
إنّ هذه الإثارات حول مفهوم الإمامة والخلافة ونظرية النص والتشكيكات التي تحوم حولها ناشئة من الفهم السنّي للإمامة.
لكن الصحيح أن الإمامة في ضوء الكتاب والسنّة تتعدى هذا الفهم، ولها بُعدٌ يختلف جوهرياً عن الفهم السطحي للإمامة الإلهية بعد النبوة.
فمدرسة أهل البيت(عليهم السلام) تعتقد بأن للأئمة الاثني عشر أدواراً اُخرى تستلزم شروطاً أشد وأدق مما هي عليه شروط القيادة السياسية [6] .
العلاقة بين العصمة والنصّ
إذا كان دور الإمام هو المرجعية الدينية، وأن مهمته التشريعية تمتد الى أبعاد مختلفة في العقائد والأحكام والأخلاق والقيادة، وجبت طاعته ووجب إتباعه والأخذ منه ولهذا تكون أقوال الإمام المعصوم وأفعاله وتقريراته حجة شرعية منجزة ومعذرة كحجية الرسول(صلى الله عليه وآله).
وهذا الدور الإلهي الخطير يستلزم عدة اُمور، منها: أن يكون معصوماً كعصمة الرسول وضرورتها في شخصه في التلقّي والتبليغ والسلوك، ويتّضح من هذا أن العصمة بهذ المعنى ليست شرطاً لمهمة القيادة السياسية فقط.
ومهمة الإمامة تستوجب أن يكون الإمام عالماً بما يحتاج اليه الناس في اُمور معاشهم ومعادهم، ولابد أن يكون أفضل من على وجه الأرض في زمانه كي يتأتى له أداء مسؤوليته.
والشيعة تعتقد بأن الرسول ليس له دور مستقل في تعيين الخليفة بل يتم نصبه والنص عليه بأمر من الله، لأن الغاية من الإمامة وملاكها الإلهي مرتبط بموضوع ختم النبوة واستمرار الهداية الربانية على طول الخط.
والحكمة من ختم النبوة مرتبطة بتعيين الإمام المعصوم، والإمام هو الذي سيتكفّل بتوفير المصالح الضرورية للاُمة الإسلامية بعد الرسول(صلى الله عليه وآله).
إذاً فالإمامة قيمتها عقائدية لا كحكم فقهي فرعي، وهذه النكتة هي التي تجعل شروط الإمامة بهذه الضخامة والسعة، وأنها تتجاوز شروط القيادة السياسية.
فإذا كانت مهمة الإمامة تتسع لمهمة أكبر من القيادة السياسية وقد استلزمت تلك الشروط فهذا يستدعي أن يكون التعامل معها والتصديق بها كأصل في الدين انطلاقاً من ضخامة رسالتها.
قال الشهيد الثاني في رسائله: الأصل الرابع التصديق بإمامة الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا الأصل اعتبرته في تحقق الإيمان الطائفة المحقة الإمامية، حتى أنه من ضروريات مذهبهم، دون غيرهم من المخالفين، فإنه عندهم من الفروع [7] .
لذا نجد أن أمر تشخيص الإمام وتعيينه خارج حدود صلاحيات البشر وقابلياتهم، ويعجز الانتخاب والترشيح أن يشخص العصمة ومَن الذي يمتلكها ويعجز الانتخاب أيضاً في أن يتوصل الى الشخص الذي يمتلك العلم الحضوري الموهوب وغيرها من القابليات والاستعدادات التي يمتلكها الأئمة(عليهم السلام) .
فعدم كون اختيار الإمام من طريق البشر شبيه بأمر النبوة التي يختارها الله ويكشف عن اختياره لها بالوحي والنص.
إن الفرق بين النبي والإمام، هو أن الله يُعرّف النبي بالمعجزة والوحي، والإمام بالمعجزة والنص.
قال الشريف المرتضى في رسائله في باب ما يجب اعتقاده في النبوة: متى علم الله سبحانه أن لنا في بعض الأفعال مصالح وألطافاً، أو فيها ما هو مفسدة في الدين، والعقل لا يدل عليها، وجب بعثة الرسول لتعريفه، ولا سبيل الى تصديقه إلاّ بالمعجزة. وصفة المعجز أن يكون خارقاً للعادة، ومطابقاً لدعوى الرسول ومتعلقاً بها وأن يكون متعذراً في جنسه أو صفته المخصوصة على الخلق، ويكون في فعله تعالى أو جارياً مجرى فعله تعالى، وإذا وقع موقع التصديق فلابد من دلالته على المصدق وإلاّ كان قبيحاً.
وما جاء عنه في باب ما يجب إعتقاده في الإمامة وما يتصل به أوجب في الإمام عصمته، لأنه لو لم يكن كذلك لكانت الحاجة إليه فيه، وهذا يتناهى في الرؤساء والانتهاء الى رئيس معصوم، وواجب أن يكون أفضل من رعيته وأعلم، لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه، في العقول. فإذا وجبت عصمته وجب النص من الله تعالى عليه وبطل اختيار الإمامة، لأن العصمة لا طريق للأنام الى العلم بمن هو عليها) [8] .
من هنا نجد أنّ النص هو أحد أركان الإمامة وفق المنظور الشيعي الذي يكشف بدوره عن تلك الخفايا المعنوية والقابليات الإلهية المودعة عند الإمام، ومن ثمّ نجد أنّ النص يفضي الى تشخيص الخليفة الذي يلي رسول الله(صلى الله عليه وآله) في مهمته الإلهية وضرورة امتدادها.
نظرية النصّ ومبدأ الشورى
فإذا كان المنظور الإسلامي للخلافة بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) يلتزم نظرية النصّ التي ترى الخلافة بعد الرسول تتسع لأكثر من القيادة السياسية. فإذاً ماهو الموقف الإسلامي من مبدأ الشورى الذي التزمه البعض كنظرية للحكم قبال نظرية النصّ، وما علاقة الشورى وقراراتها بالإمامة المنصوص عليها؟
سنتابع هذه المسألة من الناحية التاريخية أوّلاً، ثم نتعرض الى ضرورة النصّ على الخليفة من النبي(صلى الله عليه وآله) ثانياً، وبعد ذلك نتناول القيمة الشرعية لقرارات الشورى وعلاقاتها بالولاية المنصوص عليها ثالثاً، لننتهي بالنتيجة الى أن الشورى لم تكن نظرية للحكم الإسلامي، وإنّما هو مجرد مبدأ ذا قيمة توجيهية يغني القرارات الإسلامية في المجالات الحياتية وغيرها، بالوقت نفسه لا تكون تلك القرارات ملزمة للإمام المعصوم. وأنّ الشورى المصاغة في التراث الإسلامي غير الإمامي ماهي إلاّ نظرية تبرر الواقع وتحاول أن تضفي الشرعية عليه، ويمكن القول بأنّها نظرية تبرير لا نظرية تشريع .
أوّلاً: الناحية التاريخية
من الثابت أن الإسلام لم يترك الاُمة هملاً بلا نظرية للحكم انطلاقاً من أن أمر الدين والدنيا لا يتم إلاّ بوجود حاكم على رأس الاُمة يرشدها ويقودها لما فيه صلاحها في حياتها ومعادها.
وعلى هذا الأساس قالوا: إنّ الإسلام ترك للاُمة أن تختار لنفسها طريقة الحكم وما تراه الأصلح لحفظ نظامها وحفظ الشريعة، فعندئذ لا يُعد إهمالاً .
ولهذا برز اتّجاه في التاريخ الإسلامي يُسند أمر الحكم بالكامل الى الواقع التاريخي للاُمة في عصر الصحابة.
وهذه المسألة الكبرى في نظام الدين كيف نجد لها حلاًّ حين يغفلها التشريع بمصدريه القرآن والسنّة، ويفوض أمرها للاُمّة، من هنا نسأل: هل هناك قاعدة ثابتة تستند إليها الاُمّة في تعيين الخليفة؟ وما مدى شرعية هذه القاعدة؟
والجواب: قالوا هناك ثلاث وجوه في تعيين الخليفة:
الوجه الأوّل: اختيار أهل الحل والعقد ويطلق عليه (نظام الشورى).
لكن نظام الشورى هذا لم يتّخذ شكلاً واحداً عند الصحابة، لذا فقد فصلوا فيه تبعاً لذلك الاختلاف، فقالوا الشورى على شكلين:
أ ـ نظام الشورى ابتداءً كما حدث في بيعة أبي بكر وعلي بن أبي طالب.
ب ـ نظام الشورى بين عدد يعيّنهم الخليفة السابق، كما صنع عمر .
الوجه الثاني، العهد:وهو أن ينصّ الخليفة قبل موته على مَن يخلفه. وقد اتّخذ هذا العهد أشكالاً ثلاثة:
أ ـ أن يعهد الخليفة الى واحد، كما صنع أبو بكر في عهده الى عمر.
ب ـ أن يعهد الى جماعة يكون الخليفة واحداً منهم، كما صنع عمر في عهده الى ستة نفر ينتخبون الخليفة القادم من بينهم.
ج ـ أن يعهد الى اثنين فأكثر ويرتب الخلافة فيهم بأنّ يقول: الخليفة من بعدي فلان، فإذا مات فالخليفة من بعده فلان، وفي هذا النظام تنتقل الخلافة بعده على الترتيب الذي رتّبه، كما عهد سليمان بن عبدالملك الى عمر بن عبدالعزيز بعده، ثمّ الى يزيد بن عبدالملك، وكذلك رتّبها هارون في ثلاثة من بنيه.
الوجه الثالث: القهر والاستيلاء أو الغلبة بالسيف: قال الإمام أحمد: الإمامة لمن غلب [9] . وظاهر أن هذه النظرية بوجوهها إنّما هي نظرية تبرير، لا نظرية تشريع.
إنّها نظرية تبرير الواقع واضفاء الشرعية عليه والدافع الوحيد الى هذا التبرير هو اعفاء الصحابة من تهمة العمل في هذا الأمر الخطير بدون دليل من الشرع، واعفاؤهم ممّا ترتب على ذلك من نتائج.
ولأجل ذلك ظهر في هذه النظرية من التكلّف والتعسّف ما لا يخفى، ومن ذلك:
1 ـ أنّ أيّاً من هذه الوجوه الثلاثة لا يستند الى دليل شرعي البتة، ولم يعرفه حتى فقهاء الصحابة قبل ظهوره على الواقع .
2 ـ أن مبدأ الشورى المذكور في الوجه الأوّل والمأخوذ من بيعة أبي بكر، لم يكن قد تحقق في البيعة، وليس لأحد أن يدّعي ذلك بعد أن وصفها عمر بأنها فلتة، عن غير مشورة. إلاّ أن المتأخرين أضفوا عليها صبغة الشورى ليجعلوا منها في ثوبها الجديد الوجه الشرعي الأوّل في اختيار الخليفة، وأضفى عليها البعض صبغة الاجماع [10] .
3 ـ الخوف من وقوع الفتنة كان العذر المنتخب في تبرير أوّل بيعة لأوّل خليفة حين تمّت عن غير مشورة، ولم يُنتظر فيها حضور الكثير من كبار المهاجرين والأنصار ممّن ينبغي أن يكون في طليعة أهل الحل والعقد.
فالعذر في التعجل هو خوف الاختلاف والفتنة، وهذا ظاهر في نصّ خطبة عمر. لكن الغريب! أنّ الفتنة قد عادت لتصبح طريقاً شرعياً من طرق تعيين الخليفة في الوجه الثالث حيث يرون القهر والاستيلاء والتغلب بالسيف طريقاً الى الخلافة، والمتغلب دائماً هو الخليفة الشرعي الواجب الطاعة ومايزال الطريق مفتوحاً أمام كل طامع، وهل الفتنة شيء غير هذا؟
ثانياً: النصّ ضرورة على الخليفة من النبي(صلى الله عليه وآله)
قال الفرّاء في الأحكام السلطانية: لا نزاع في ثبوت حق الخليفة في النصّ على مَن يخلفه، ولا شكّ في نفاذ هذا النصّ، لأن الإمام أحقّ بها، فكان اختياره فيها أمضى ولا يتوقف ذلك على رضا أهل الحل والعقد [11] . وإنّما صار ذلك للخليفة خوفاً من وقوع الفتنة واضطراب الاُمّة [12] . فمن أجل ذلك كان بعض الصحابة يراجع عمر ويسأله أن ينصّ على مَنْ يخلفه [13] .
وأيّد ذلك ابن حزم فقال: وجدنا عقد الإمامة يصحّ بوجوه:
أوّلها وأصحها وأفضلها أن يعهد الإمام الميّت الى إنسان يختاره إماماً بعد موته، سواء فعل ذلك في صحّته أو عند موته، كما فعل رسول الله(صلى الله عليه وآله) بأبي بكر، وكما فعل أبو بكر بعمر، وكما فعل سليمان ابن عبدالملك بعمر بن عبدالعزيز .
قال: وهذا الوجه الذي نختاره، ونكره غيره، لما في هذا الوجه من اتصال الإمامة، وانتظام أمر الإسلام وأهله، ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب ممّا يتوقع في غيره من بقاء الاُمّة فوضى، ومن انتشار الأمر وحدوث الاطماع [14] . إلاّ أنّ النصّ المدعى على أبي بكر لم يثبت، بل لم يدّع وجوده أحد، بل تسالمت الاُمّة على عدمه، فمن أراد أن يثبت مثل هذا النصّ على أبي بكر بالخصوص، فعليه أن ينفي حادثة السقيفة جملة وتفصيلاً. وعليه أن يكذب بكل ما ثبت نقله في الصحاح من كلام أبي بكر وعمر وعلي والعباس والزبير في الخلافة. وعليه أن يهدم بعد ذلك كل ما قامت عليه نظرية أهل السنّة في الإمامة، فلم تُبنَ هذه النظرية أوّلاً إلاّ على أصل واحد، وهو البيعة لأبي بكر بتلك الطريقة التي تمّت في السقيفة وبعدها!! فمن تلك الواقعة أوّلاً جاءت نظرية الشورى بين أهل الحلّ والعقد. وعليه أن ينفي ما تحقق عندهم من الاجماع «الاجماع على أنّ النصّ منتف في حق أبي بكر» [15] .
من هنا ساق الغزالي كلاماً موافقاً لهذا الاجماع قوّض فيه ما بنى عليه ابن حزم قوله.
قال الغزالي متسائلاً: فهلا قُلتم إنّ التنصيص واجب من النبي والخليفة كي يقطع ذلك دابر الاختلاف؟
ثم أجاب قائلاً: قلنا إنه لو كان واجباً لنصّ عليه الرسول(صلى الله عليه وآله)ولم ينصّ هو، ولم ينصّ عمر أيضاً [16] .
وحين يواصل ابن حزم عرض نظريته تراه يلغي بالكامل مبدأ الشورى واختيار أهل الحل والعقد، ويسند أمر اختيار الخليفة الى النصّ! بسبب كونه مقتنعاً بضرورة النصّ، ولكنه أراد نصّاً منسجماً مع الأمر الواقع، وان لم يسعفه الدليل!!
وإن النصّ لم يختف الى الأبد في هذه النظرية، والشورى هنا ليست مطلقة العنان، فليس لأهل الحل والعقد أن ينتخبوا من شاءوا بلا قيد، لأن هناك حدّاً تلتزمه الشورى، وهذا الحد إنّما رسمه النصّ الثابت.
قالوا: إن من شرط الإمامة: النسب القرشي، فلا تنعقد الإمامة بدونه.. وعلّلوا ذلك بالنصّ الثابت فيه، فقد ثبت عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «الأئمة من قريش».
وقال(صلى الله عليه وآله): «قدموا قريشاً ولا تتقدموها» وليس مع هذا النصّ المسلّم شبهة لمنازع، ولا قول لمخالف [17] .
واشترطوا لهذا القرشي أن يكون قرشياً من الصميم، من بني النضر بن كنانة، تصديقاً للنصّ [18]
وقال الإمام أحمد: «لا يكون من غير قريش خليفة» [19] .
واستدلوا على تواتر هذا النصّ بتراجع الأنصار وتسليمهم الخلافة للمهاجرين القرشيين حين احتجّوا عليهم بهذا النصّ في السقيفة [20] .
وقال ابن خلدون: بقي الجمهور على القول باشتراطها ـ أي القرشيّة ـ وصحة الخلافة للقرشيّ ولو كان عاجزاً عن القيام باُمور المسلمين [21] .
وهكذا ثبت النصّ الشرعي، وثبت تواتره، وثبت الإجماع عليه.
وواضح هذا حين تم الانتصار لمبدأ النصّ على مبدأ الشورى عندما رأى الخليفة الثاني ضرورة النصّ على من يخلفه.
فدخل النصّ إذاً في قمة النظام السياسي، رغم أنه يلغي قاعدة الشورى بالكامل.
ويضاف لذلك أن النصّ النبوي الشريف «الأئمة من قريش» يهزم مبدأ الشورى أمام السيف! فمن تغلب على الاُمّة وانتزع الخلافة بالسيف وكان قرشياً صحت خلافته، لأنها لا تخرج عن النصّ المتقدم.
وهكذا لا يعتنى بالشروط الواجب توفرها في الخليفة بالاجتهاد والعدل والتقوى، فإذا كان الخليفة قرشياً صحّت خلافته وإن كان ظالماً بل عاجزاً من أمر الخلافة!
إذاً، فالشورى ينبغي أن لا تخرج عن دائرة هذا النصّ فلا تنتخب إلاّ قرشياً من الصميم.
وملخّص المسألة ثبت لدينا نصّ صريح صحيح وفاعل في هذه النظرية وهو الحديث الشريف: «الأئمة من قريش»، وقد أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والسير بألفاظ مختلفة وهذا هو محصلها. ولكن هذا النصّ يبقى بحاجة الى التخصيص وذلك لاُمور منها:
1 ـ إنّ النصّ المتقدم «الأئمة من قريش» بمفرده لا يحقّق للإمامة الهدف المنشود والذي منه حراسة الدين والمجتمع، حيث أدرك هذه الحقيقة الصحابة أنفسهم منذ انتهاء الخلافة الراشدة.
ففي صحيح البخاري: لما كان النزاع دائراً بين مروان بن الحكم وهو بالشام، وعبدالله بن الزبير وهو بمكة انطلق جماعة الى الصحابي أبي برزة الأسلمي(رضي الله عنه) فقالوا: يا أبا برزة، ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فقال: إني احتسب عند الله أني أصبحت ساخطاً على أحياء قريش، إنّ ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلاّ على الدنيا، وأنّ الذي بمكة والله إن يقاتل إلاّ على الدنيا!! [22]
2 ـ وثمة نصوص اُخرى صحيحة تضيّق دائرة النصّ المتقدم، منها: ان النبي حذّر من الاغترار بالنسب القرشي وأنذر بأنّ ذلك سيؤدي الى هلاك الاُمّة وتشتت أمرها.
جاء في صحيح البخاري، عنه(صلى الله عليه وآله) أنه قال: «هَلكة اُمّتي على يَد غلمة من قريش» [23] .
كيف إذاً سيتم التوفيق بين النّصين «الأئمة من قريش» و«هلكة اُمتي على يدي غلمة من قريش»؟
لابد أنّ يتم ذلك عن طريق التخصيص فيما ورد من الأخبار بحق قريش، وهناك نوعان من التخصيص:
أ ـ تخصيص السلب: توجد نصوص صريحة تستثني قوماً من قريش فتبعدهم عن دائرة التكريم.
قال ابن حجر الهيثمي في الحديث المروي بسند حسن أنّه(صلى الله عليه وآله)قال: «شر قبائل العرب: بنو اُمية، وبنو حنيفة، وثقيف».
قال: وفي الحديث الصحيح قال الحاكم: على شرط الشيخين عن أبي برزة(رضي الله عنه) أنّه قال: كان أبغض الأحياء أو الناس الى رسول الله بني أُمية [24] . والذي ورد في ذم آل الحكم أبي مروان خاصّة كثير ومشهور. فهل يصحّ أن تسند الإمامة الى شرّ قبائل العرب وأبغض الناس الى رسول الله(صلى الله عليه وآله)؟!
فإذا أصبح هؤلاء هم الحكّام في الواقع فعلينا أن نشهد أن هذا الواقع منحرف عن النصّ، بدلاً من أن نسعى الى تبريره واخضاعه للنصّ.
ب ـ تخصيص الإيجاب: الحديث الذي ميّز قريشاً بالاصطفاء على سائر القبائل لم يقف عند دائرة قريش الكبرى، بل خصّ منها طائفة بعينها فقال: «إنّ الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» [25] .
وهذا تقديم لبني هاشم على سائر قريش.
ساق ابن تيمية هذا الحديث الصحيح، وأضاف قائلاً: (وفي السنن أنّه شكا إليه العباس أنّ بعض قريش يحقّرونهم! فقال(صلى الله عليه وآله): «والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنّة حتّى يحبّوكم لله ولقرابتي» وإذا كانوا أفضل الخلائق فلا ريب أنّ أعمالهم أفضل الأعمال.. ففاضلهم أفضل من كلّ فاضل من سائر قبائل قريش والعرب، بل وبني اسرائيل وغيرهم) [26] .
وليس المقام مقام تفضيل وحسب، بل إنّ قريشاً لا يصحّ لها ايمان ما لم تحبّ بني هاشم حبّين: لله، ولقرابة الرسول .
فهل يصحّ أن تكون قريش كلّها سواء في حقّ التقدم والإمامة، وفيها بنو هاشم الذين رفعهم النصّ الى أعلى منزلة، وفيها بنو اُمية الذين خفضهم النصّ الى أردى الرتب؟!
إذا كان الواقع قد آل الى هذه الحال، فعلينا أن نشهد أنّه واقع منحرف عن النصّ، لا أن نسعى الى تبريره.
وخلاصة لما تقدم يبدو بكلّ وضوح أننا هنا قد أخفقنا في تحقيق نظرية منسجمة متماسكة في موضوع الإمامة، وأنّ السبب الحقيقي لهذا الاخفاق هو متابعة الأمر الواقع والسعي لتبريره وجعله مصدراً رئيساً في وصف النظام السياسي.
إنّ تناقضات الأمر الواقع في أدواره المتعدّدة قد ظهرت جميعها في هذه النظرية، ممّا أفقدها قيمتها كنظرية إسلامية في معالجة واحدة من قضايا الإسلام الكبرى.
فالقول بالنصّ الشرعي لم يقف عند جوهر النصّ، ولا التزم شروطه وحدوده.
والقول بالشورى تقهقر أمام نصّ الخليفة السابق وصلاحيات الشورى، والقهر والاستيلاء، والتغلّب بالسيف.
أما نظام أهل الحلّ والعقد فهو أشدّ غموضاً.
فمرّة يكون أهل الحلّ والعقد رجلاً واحداً نصّب نفسه فتابعه اثنان كما في عقد الزواج، أو تابعه أربعة، أو يكونوا ستّة يعيّنهم الخليفة السابق دون الاُمّة، بل تطوّر الأمر عن هذا كثيراً، حتى إنّ فيلسوفاً مدقّقاً كابن خلدون قد جعل حاشية الخليفة وبطانته وأقاربه ـ بصرف النظر عن مدى علمهم واجتهادهم وتقواهم ـ هم أهل الحلّ والعقد الذين عارضوا الخليفة المأمون أن ينقل الخلافة الى عليّ الرضا من بعده» [27] !
والحقيقة التي نرجو أن لا تصدم أحداً أنّ هذا قد ظهر من قبل، في النصف الثاني من خلافة عثمان، حيث برز على رأس أصحاب الرأي والمشورة رجال من قرابته ـ بني اُميّة ـ خاصّة، لم يكونوا من اُولي الفضل والاجتهاد والسابقة في الدين، مع كثرة من اجتمعت فيهم هذه الخصال في ذلك الوقت!
وكان أهل الحلّ والعقد هؤلاء هم: عبدالله بن عامر، وعبدالله بن سعد بن أبي سرح [28] ، وسعيد بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، ومروان بن الحكم!
نقل الطبري من طريقين: أنّ عثمان أرسل الى معاوية وعبدالله ابن سعد بن أبي سرح، وسعيد بن العاص، وعمرو بن العاص، وعبدالله بن عامر، فجمعهم ليشاورهم في أمره، فقال لهم: إنّ لكلّ امرىً وزراء ونصحاء، وإنّكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي.. وقد صنع الناس ما قد رأيتم، وطلبوا إليّ أن أعزل عمّالي، وأن أرجع عن جميع ما يكرهون الى ما يحبّون، فاجتهدوا رأيكم وأشيروا عليَّ.
فلمّا أشاروا عليه عمل بما رآه من مجموع مشورتهم; فردّهم على أعمالهم، وأمرهم بالتضييق على من قبلهم، وأمرهم بتجمير الناس في البعوث [29] ، وعزم على تحريم اُعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا اليه [30] .
هذه الوجوه المتناقضة كلّها من المستحيل أن تجتمع في نظرية واحدة، فتكون نظرية منسجمة وذات تصوّر واضح ومحدّد ومفهوم.
هذا كلّه، وبقدر ما يثيره من شكوك حول صلاحية هذه النظرية، فإنّه يرجّح الرأي الآخر الذي يذهب الى اعتماد النصّ الشرعي في تعيين خليفة الرسول.
الى هذه النتيجة أيضاً خلص الدكتور أحمد محمود صبحي وهو يدرس نظرية الإمامة، إذ قال: «أمّا من الناحية الفكرية فلم يقدّم أهل السنّة نظرية متماسكة في السياسة تُحدد مفاهيم البيعة والشورى وأهل الحلّ والعقد، فضلاً عن هوّة ساحقة تفصل بين النظرية والتطبيق، أو بين ماهو شرعي وبين ما يجري في الواقع.
لقد ظهرت نظريات أهل السنّة في السياسة في عصر متأخّر بعد أن استقرّ قيام الدولة الإسلامية على الغَلبة.. كما جاء أكثرها لمجرّد الردّ على الشيعة.. والتمس بعضها استنباط حكم شرعي من اُسلوب تولّي الخلفاء الثلاثة الأوائل.
وإنّ الهوّة الساحقة بين تشريع الفقهاء وبين واقع الخلفاء، فضلاً عن تهافت كثير من هذه الآراء واخفاقها في استنباط قاعدة شرعية، هو ما مكّن للرأي المعارض ـ القول بالنصّ ـ ممثّلاً في حزب الشيعة» [31]
ثالثاً: القيمة الشرعية لقرارات الشورى وعلاقتها بالولاية المنصوص عليها
إن من أهم المستندات الشرعية التي تعتمدها نظرية الشورى هي الآية الكريمة: (وشاورهم في الأمر) .
هذه الآية تلزم الإمام الحاكم بوجوب الشورى على رأي من يقول: (إن الآية في خطابها للرسول صريحة في الأمر بالشورى والأمر ظاهر بالوجوب، والآية بهذا المعنى ليس أكثر من أن تدعو لاستشارة المسلمين (وشاورهم) وحيث لا يمكن استشارة المسلمين جميعاً فلابد من الأخذ بالميسور في هذه الاستشارة وهو استشارة ذوي الرأي والخبرة) [32] .
وبهذا المعنى هل أن الشورى مطلوبة بحد نفسها، أو أنها طريق يتحقق بواسطتها غايات اُخرى؟
لا شك أن الشورى ليست مطلوبة في حد نفسها ولا هي موضوع مستقل للطلب، وإنّما الشورى طريق الى تحقيق غايات اُخرى وأهم هذه الغايات التعرف على وجهات نظر الآخرين وتصوراتهم ومناقشاتهم وأفكارهم. وهذه التصورات والأفكار عندما تتوارد من منابع مختلفة وتجتمع في موضع واحد تكون لها قيمة كبيرة في توجيه سياسة الحكم والإدارة والاقتصاد والأمن والحرب وغير ذلك في البلد، وهذا الوجه يتم في غير المعصومين من أولياء الاُمور.
الى هنا قد اتّضح الغرض من تشريع الشورى، لكن السؤال عن القيمة الشرعية التي تتمتع بها الشورى، وهل تعتبر النتيجة التي تتمخض عنها الشورى بالإجماع أو بالأكثرية قراراً ملزماً لولي الأمر أم لا ؟
يتجه علماء السنّة في الإجابة على هذا السؤال على نحو إتجاهين:
الأول: يرى هذا الإتجاه بأن نتيجة الشورى ملزمة لولي الأمر وللنظام بشكل عام.
ومن هؤلاء: الشيخ محمد عبده ; يقول في تفسير: (اُولي الأمر)معناه أصحاب أمر الاُمة في حكمها، وهو الأمر المشار إليه في قوله تعالى: (وأمرهم شورى بينهم) ولا يمكن أن يكون شورى بين جميع أفراد الاُمة، فتعين أن يكون شورى بين جماعة تمثل الاُمة... وما هؤلاء إلاّ أهل الحل والعقد الذين تكرر ذكرهم، ويضيف: «ويجب على الحكّام الحكم بما يقرره اُولو الأمر ـ أصحاب الشورى ـ وتنفيذه» [33] .
الثاني: يرى هذا الاتجاه بأن قيمة الشورى توجيهية فقط وليس لها قيمة شرعية في إلزام ولي الأمر بالتنفيذ.
ومن هؤلاء: القرطبي، إذ يقول في تفسيره: «والشورى مبنية على اختلاف الآراء والمستشير ينظر في ذلك الاختلاف، وينظر أيّها أقرب الى الكتاب والسنّة إن أمكنه، فإذا أرشده الله تعالى الى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلاً عليه» [34] .
أما فقهاء الإمامية فيذهبون الى الرأي الثاني في تفسير آية الشورى، يقول الشيخ محمد جواد البلاغي: (وشاورهم في الأمر) واستصلحهم، واستمل قلوبهم بالمشاورة، لا لأنهم يفيدونه سداداً وعلماً بالصالح، كيف وإنّ الله مسدده (وما ينطق عن الهوى* إن هو إلاّ وحي يوحى) فإذا عزمت على ما أمرك الله بنور النبوة وسددك فيه (فتوكّل على الله) [35] .
فالشورى في نظر مدرسة أهل البيت تتلخص في أن رأي المسلمين ليس ملزماً لرسول الله(صلى الله عليه وآله)حيث قال تعالى: (فإذا عزمت فتوكّل)، إذاً فالقيام بالعمل يكون على أساس عزم الرسول(صلى الله عليه وآله)وليس على ما يرتئيه المؤمنون.
ثم إن مشاوراته(صلى الله عليه وآله) كانت في مقام استجلاء رأي المسلمين في كيفية تنفيذ الأحكام الإسلامية، وليست في مقام استنباط الحكم الشرعي بالتشاور; أضف الى كل ذلك أن الله تعالى قال: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً) [36] .
إذاً رجحان المشاورة ينحصر بمورد لم يقض الله ورسوله فيه أمراً، وأمّا في ما قضى الله ورسوله فيه أمراً تكون المشاورة حينئذ معصية لله ولرسوله وضلالاً مبيناً [37] .
وعليه، فالشورى ذات قيمة توجيهية تغني القرارات الإسلامية في كل المجالات الحياتية وغيرها، وهي غير ملزمة للإمام المعصوم، لأنها لا تشرع حكماً قبال قول المعصوم وفعله وتقريره، وتنحصر في المورد الذي لم يقض الله ورسوله فيه أمراً. وأما من الناحية التاريخية كما ذكرنا لم تكن الشورى كنظام سياسي شرعي للحكم، لأنها جاءت كتبرير للأمر الواقع والسعي لجعله مصدراً رئيسياً في وصف النظام السياسي الحاكم آنذاك، وأن الخلافة لا تتم إلاّ بنص من النبي للخليفة الذي بعده.
العلاقة بين البيعة والنصّ
البيعة تكريم للإنسان لكي يقرر مصيره في الدعوة الى الله والجهاد في سبيله أو شؤون الحكم والسياسة.
والإسلام بطبيعته لا يريد أن تتقرر حياة المسلمين بمعزل عن إرادتهم ووعيهم وقرارهم.
والطاعة هنا تبرز أهميتها في تنفيذ مهمات الدعوة والتبليغ ومهمات الدولة ومهمات الجهاد، وتتأكد الطاعة للإمام المعصوم في أقسامها الثلاثة عبر البيعة.
ولا يعني أن الطاعة تسقط عن الإمام المعصوم عند عدم البيعة له.
فإذا كانت البيعة وفق هذا المنظار تؤكد وتوثق الإمامة والطاعة له بعد افتراض ثبوت الإمامة، فهل يمكن لنا أن نقول: إن البيعة شرط لصحة طاعة الإمام، أو أنها شرط لوجوب الطاعة وانعقاد الإمامة وبدون البيعة لا إمامة، كما أنه لا صحة للطاعة أيضاً؟
فنقول: ان البيعة تأكيد وتوثيق للالتزام بولاية وسيادة ولي الأمر وليست إنشاءً للولاية أو شرطاً لصحة الطاعة. فالطاعة والإمامة لا تتوقف على البيعة لمن ثبتت له الولاية بالنص.
ولهذا نجد الرسول(صلى الله عليه وآله) قد عمل بالبيعة أثناء حياته انطلاقاً من هذا المفهوم، كما هو واضح في بيعة العقبة الاُولى وبيعة العقبة الثانية وبيعة الغدير.
هذه الصور للبيعة قد تمّت مع رسول الله(صلى الله عليه وآله) مع أن الولاية ثابتة له قبل حدوثها، وبيعة المسلمين أو عدم بيعتهم له(صلى الله عليه وآله) في الاستجابة لدعوته(صلى الله عليه وآله) أو الجهاد والإمرة، لم تغيّر من حق الرسول على الاُمة في الطاعة في أمر الدعوة والجهاد والإمرة.
وكذلك الإمرة كانت ثابتة لعلي(عليه السلام) بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) في غدير خم. فلم تثبت هذه الإمرة يومئذ ببيعة المسلمين له وإن كان رسول الله(صلى الله عليه وآله) قد أمرهم بذلك، فإن هذه البيعة لا تزيد قيمتها من الناحية التشريعية على تأكيد هذه الولاية والطاعة لها. وكون الإمامة حاصلة بالعهد، قد مضى عليه أهل السنّة أيضاً.
قالوا: إذا عهد الخليفة الى آخر بالخلافة بعده، فإنّ بيعته منعقدة، وإن رضى الاُمة بها غير معتبر، ودليل ذلك أن بيعة الصديق لعمر لم تتوقف على رضى بقية الصحابة [38] .
هذا، مع أننا لا نجد بين أبي بكر وعمر بيعة، وإنّما هو عهد بالخلافة لا غير.
فعهد النبي(صلى الله عليه وآله) أولى أن يُتبع، بلا مسوغ للخلاف، فهو ماض وبه تحققت الخلافة لعلي(عليه السلام) بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) مباشرة سواء بايعته الاُمة على الطاعة أو لم تبايع، فالبيعة إنّما تنشئ عقد الطاعة وتسليم مقاليد الحكم والادارة ; فهذا لا يتم إلاّ بالبيعة وقد عرضت على علي من قبل العباس، فرفض أن تكون إلاّ جهرة على الملأ وعامة في المسجد النبوي الشريف، ثم لما أتته بالبيعة فبايع الناس على ذلك، فكانت البيعة على الحكم، وهكذا كان الأمر مع الحسن(عليه السلام)وحين حُبست البيعة عن الأئمة الذين اختارهم الله ورسوله فقد حيل بينهم وبين ممارسة الحكم والادارة العامة، دون أن يسلبهم ذلك حق الإمامة الثابت لهم، شأنهم في ذلك شأن الكثير من الأنبياء الذين عصتهم اُممهم وحالت بينهم وبين ممارسة دورهم الحقيقي في القيادة والارشاد والتوجيه، دون أن يُسلبهم ذلك منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى بها [39] .
إذاً فقيمة البيعة بحضور الإمام المعصوم لا تزيد على كونها تأكيداً وتوثيقاً ممن ثبتت الولاية له بالنص .
كما أن البيعة لا تنشئ ولاية قبال الولاية للشخص المنصوص عليه كالرسول أو الإمام، والنصّ للإمام يوجب طاعته وحرمة التخلف عن بيعته.
الرسول يعمل لتركيز نظرية النص
ولو دققنا النظر من الناحية التاريخية ولاحظنا خطوات الرسول(صلى الله عليه وآله) في تربية الاُمّة وتثقيفها حول أخطر مسألة إلهية وهي الخلافة لوجدناه قد ركّز في ذهنها نظرية النصّ دون الشورى، ولا يوجد أي نشاط يذكر للرسول(صلى الله عليه وآله) في تثقيف الاُمة وتربيتها على غير هذه النظرية ابتداءً من نزول قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين) . وحتى نزول قوله تعالى: (يا أيّها الرسول بلّغ ما اُنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته والله يعصمك من الناس) .
فقد جاء عن ابن عباس عن الإمام علي(عليه السلام)أنه قال: «لما نزلت هذه الآية (وأنذر عشيرتك الأقربين) على رسول الله(صلى الله عليه وآله)دعاني رسول الله(صلى الله عليه وآله)فقال لي: يا علي إن الله أمرني أن انذر عشيرتي الأقربين، فضقت بذلك ذرعاً، وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فَصَمتُّ عليه حتى جاءني جبرائيل، فقال: يا محمد إلاّ تفعل ما تؤمر به يعذبك ربّك، فاصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رِجل شاة واملأ لنا عُسّاً من لبن، ثم اجمع لي بني عبدالمطلب حتى اُكلّمهم واُبلغهم ما اُمرت به، ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم له وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه، فيهم أعمامه أبو طالب والحمزة والعباس وأبو لهب ـ الى أن قال ـ فتكلم رسول الله(صلى الله عليه وآله) فقال: يا بني عبدالمطلب إنّي والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيّكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم ؟ ـ قال الإمام علي(عليه السلام) ـ فأحجم القوم عنها جميعاً فقلت وإنّي لأحدثهم سنّاً، وأرمصهم عيناً... أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي ثم قال(صلى الله عليه وآله)إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له واطيعوا . قال علي(عليه السلام) ـ فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع» [40] .
هكذا أخذ رسول الله(صلى الله عليه وآله) يهيّئ الاُمة بدءً بعشيرته الأقربين ويوجّهها نحو خلافة علي(عليه السلام)من بعده، ناصاً على الاُخوّة والوصاية والخلافة ولزوم الانقياد له. وكان النبي(صلى الله عليه وآله)يسلّط الضوء على معاني الآيات القرآنية التي كانت تنزل في حقّه(عليه السلام)خصوصاً الآيات التي لها صلة بموقع الخلافة والإمامة.
ذكر الزمخشري في تفسير قوله تعالى: (إنّما وليّكم الله ورسُولُه والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويُؤتون الزكاة وهم راكعون) [41] : إن هذه الآية نزلت في الإمام علي(عليه السلام) حين سأله سائل، وهو راكع في صلاته فطرح له خاتمه [42] .
ولإزالة الالتباس، وقطعاً لدابر أي تأويل حول المراد بالولي وتشخيصه في مثل هذه الموارد صرّح النبي(صلى الله عليه وآله) في أكثر من مناسبة قائلاً: «إنّ عليّاً مني وأنا منه، وهو وليّ كل مؤمن بعدي» [43] . ولتأكيد ولاية الإمام علي(عليه السلام)، ودوره المهم في تبيين معالم الرسالة الإسلامية وتحقيق أهدافها من خلال ممارسة القيادة لتطبيق أحكامها وصيانتها من كل ما يمكن أن يشوبها من تشويه وتحريف بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) قال رسول الله(صلى الله عليه وآله): «علي منّي وأنا من عليّ ولا يؤدي عنّي إلاّ أنا أو عليّ...» [44]
ورسّخ النبي(صلى الله عليه وآله) هذا المفهوم عمليّاً جهاراً نهاراً في قصة تبليغ سورة براءة، وقد أخرج هذه الرواية الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي بكر حين قال: «إنّ النبي بعثه ببراءة الى أهل مكة، فسار ثلاثاً ثم قال لعليّ: إلحقه، فردّ عليّ أبا بكر وبلّغها، فلما قدم أبو بكر على رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال: يا رسول الله حدث فيّ شيء؟! قال(صلى الله عليه وآله): ما وجدت فيك إلاّ خيراً، لكنني اُمرت أن لا يبلّغ عنّي إلاّ أنا أو رجل منّي...» [45] .
وفي الكشاف: روى أنّ أبا بكر لما كان ببعض الطريق ـ أي لتبليغ سورة براءة ـ هبط جبرائيل(عليه السلام)، فقال: «يا محمّد لا يبلّغنّ رسالتك إلاّ رجل منك، فأرسل عليّاً...» [46] .
وأخيراً ختم القرآن الكريم هذا الموضوع الحيوي والمهم ـ وهو عملية الإعداد الفكري والتربوي على كيفية التعامل مع موضوع الخلافة والولاية بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ـ في آخر ما نزل منه في آية التبليغ ثم في آية إكمال الدين بعد قصة غدير خم المشهورة، بحيث لم يبق هناك عذرٌ لمعتذر. وقصة الغدير ـ كما تناقلها الرواة مع بعض الاختلاف ـ هي كما يأتي:
لما رجع رسول الله(صلى الله عليه وآله) من حجة الوداع، نزل عليه الوحي مُشدّداً: (يا أيّها الرسول بلّغ ما اُنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته والله يعصمك من الناس) [47] فحطّ الركب عند غدير خم، وجمع الناس في منتصف النهار، والحرُّ شديد، وخطب فيهم النبي(صلى الله عليه وآله)قائلاً: «كأني قد دُعيت فأجبتُ وإني تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي ـ وفي رواية مسلم [48] وأهل بيتي ـ فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض...» ثم قال: «إنّ الله مولاي، وأنا مولى كلّ مؤمن»، ثم أخذ بيد علي فقال: «من كنتُ مولاه فهذا وليُّه ـ أو فهذا مولاه [49] ـ اللّهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، واخذُل من خذله، وانصر من نصره [50] .. وأدر الحقّ معه حيثما دار...» [51] .
وقد أعقبَ هذا الحدث الكبير نزول الوحي مرة اُخرى بقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتُ عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) [52] .
وقد ورد في بعض النصوص المروية أن الرسول(صلى الله عليه وآله) قال بعد نزول هذه الآية في ذلك اليوم المشهود وهو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة [53] يوم الغدير قال: «الله أكبر، الحمدُ لله على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الرب برسالتي وبالولاية لعلي بعدي» [54] .
وفي رواية لأحمد: «فلقيه عمر بن الخطاب ـ أي لقي الإمام عليّاً ـ بعد ذلك، فقال له: هنيئاً أصبحت وأمسيتَ مولى كلّ مؤمن ومؤمنة...» [55] .
ولا نجد في حياة الرسول(صلى الله عليه وآله) جهداً آخر يذكر قد استهدفه رسول الله(صلى الله عليه وآله) في تثبيت مسألة الخلافة من بعده غير نظرية النص التي تعني في محتواها الشرعي أكبر من كونها زعامة وقيادة سياسية، وإنّما هي هداية إلهية تتكفل تحقيق ما تريده رسالة النبي(صلى الله عليه وآله). حيث نصّ القرآن على النبي(صلى الله عليه وآله) إن لم يبلّغ ذلك ـ الذي بلّغه عن أمر الخلافة والولاية من بعده ـ لما بلّغ رسالة ربّه التي كان جاهداً على تبليغها خلال أكثر من عقدين من عمره المبارك.
الطرق المحتملة والواقع التاريخي
وقد ناقش الشهيد الصدر(رضي الله عنه) هذه المسألة في واقعها التاريخي ضمن عدة احتمالات قد تعترض الذهن بخصوصها.
منها: احتمال أن الرسول قد سلك طريق الإهمال ـ أي أن الرسول لم يتحرك أصلاً لإبلاغ المسلمين وتربيتهم على أمر الولاية والقيادة من بعده ـ وهذا الافتراض باطل لأنه يتعارض مع مقام النبوة المحيط بكل ما يرتبط بالرسالة ويتعارض مع النصوص التي تكلّمت عن اهتمام الرسول بأمر الاُمة من بعده في حياته وقبيل وفاته وفي اللحظات الأخيرة من حياته المباركة بالخصوص [56] .
كما ناقش الشهيد الصدر الطريق الثاني ـ وهو افتراض الشورى ـ بقوله: إن الوضع العام الثابت عن الرسول وجيل المهاجرين والأنصار ينفي فرضية أن النبي(صلى الله عليه وآله) قد انتهج هذا الطريق.
إذ لو كان النبي(صلى الله عليه وآله) قد أسند الأمر الى جيل المهاجرين والأنصار دون حصره بأهل بيته(عليهم السلام)لكان من أبده الأشياء التي يتطلبها هذا الموقف هو أن يقوم الرسول(صلى الله عليه وآله)بعملية توعية للاُمة على نظام الشورى وتفاصيله وإعداد المجتمع الإسلامي لتقبل هذا النظام.
ولو كان النبي(صلى الله عليه وآله) قد قام بتلك التوعية لكان من الطبيعي أن تنعكس في الأحاديث المأثورة عن النبي(صلى الله عليه وآله) وفي ذهنية جيل المهاجرين والأنصار مع أننا لا نجد في الأحاديث الواردة عن النبي(صلى الله عليه وآله) أي صورة تشريعية محددة لنظام الشورى.
وأما ذهنية المهاجرين والأنصار فلا نجد فيها ملامح أو انعكاسات كاشفة عن توعية من هذا القبيل فإنّ هذا الجيل صدر عن اتجاهين:
أحدهما: الاتجاه الذي تزعمه أهل البيت(عليهم السلام) وكان يؤمن بالوصية.
والآخر: الاتجاه الذي مثّلته السقيفة وخط الخلافة الذي قام فعلاً بعد وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله).
وكل الأرقام والشواهد في سيرة أصحاب هذا الاتجاه تدل بصورة لا تقبل الشكّ، على أنه لم يكن يؤمن بالشورى، اذ عهد أبو بكر حين اشتد به المرض الى عمر ولم يستشر أحداً وولاّه على الاُمة دون مشورة المسلمين أو أهل الحل والعقد منهم، وسار عمر على المنهج نفسه حين عيّن ستة يختارون من بينهم واحداً وكان يقول: «لو كان سالم حيّاً ما جعلتها شورى». وهذا تصريح منه بعدم الإيمان بمبدأ الشورى [57] .
ولو كان النبي(صلى الله عليه وآله) قد قرر أن يجعل من جيل المهاجرين والأنصار قيّماً على الدعوة من بعده، لتحتم عليه أن يعبّئ هذا الجيل تعبئة رسالية وفكرية واسعة تجعله قادراً على مواجهة المشكلات الفكرية التي تواجهها الدعوة في حالة انفتاحها على شعوب متعددة وأراض جديدة.
ولكننا لا نجد أثراً لذلك الإعداد، والمعروف عن الصحابة أنهم كانوا يتحاشون من ابتداء النبي(صلى الله عليه وآله) بالسؤال، بل أمسكوا عن تدوين آثار الرسول(صلى الله عليه وآله) وسنته على الرغم من أنها المصدر الثاني من مصادر الإسلام في مجال التشريع، مع أنّ التدوين هو الاُسلوب الوحيد لحفظها.
وقد أثبتت الأحداث بعد وفاة النبي(صلى الله عليه وآله) أن جيل المهاجرين والأنصار لم يكن يملك أي تعليمات محددة عن كثير من المشاكل الكبيرة، حتى أن المساحة الهائلة من الأرض التي امتد إليها الفتح الإسلامي لم يكن لدى الخليفة والوسط الذي يسنده أي تصور محدد عن حكمها الشرعي، وعما إذا كانت تقسّم بين المقاتلين أو تجعل وقفاً على المسلمين عموماً، بل اختلفوا في عدد التكبيرات في صلاة الميت فبعضهم كان يقول: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله) يكبر خمساً، وآخر يقول: سمعته يكبر أربعاً.
وهكذا اتّضح أن النبي(صلى الله عليه وآله) لم يسلك الطريق الثاني أيضاً. وأن إسناد القيادة والقيمومة الى الاُمة كان إجراءً مبكراً وقبل وقته الطبيعي، فلم يبق إذاً إلاّ الطريق الثالث، وهو أن النبي(صلى الله عليه وآله)قد أعدّ بأمر الله تعالى علياً(عليه السلام) وعيّنه قيّماً على الرسالة والاُمة، باعتباره المرشح الطبيعي لهذه القيمومة، لعمق وجوده في حركة الرسالة واستيعابه لها وقدرته على الاشراف على حركتها بعد الرسول(صلى الله عليه وآله)كما أثبتت الأحداث التاريخية ذلك خلال ثلاثة عقود من عمره المبارك بعد الرسول(صلى الله عليه وآله) باعتراف المؤرخين.
وليس ما تواتر عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) من النصوص في أهل بيته(عليهم السلام)وفي علي إلاّ تعبيراً عن سلوكه(صلى الله عليه وآله) للطريق الثالث الذي كانت تفرضه وتدل عليه قبل ذلك طبيعة الأشياء [58] .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] المؤمنون: 115.
[2] الدخان: 38.
[3] الذاريات: 56.
[4] الغاشية : 21.
[5] الجمعة: 2.
[6] راجع : بحث حول الإمامة للسيد كمال الحيدري.
[7] العقائد الاسلامية : 1/282 مركز المصطفى، نقلاً عن رسائل الشهيد الثاني: 2 / 145.
[8] العقائد الاسلامية 1/281، مركز المصطفى، رسائل الشريف المرتضى: 3/18.
[9] الأحكام السلطانية، للفراء: 20، 22، 23 .
[10] منهاج السنّة لابن تيمية: 3/215، 217، 218.
[11] الأحكام السلطانية، للفرّاء: 10، الأحكام السلطانية، للبغوي: 25، 26 .
[12] الفصل: 4/169، تاريخ الاُمم الإسلامية، للخضري: 1/196.
[13] الكامل في التاريخ: 3/65.
[14] الفِصَل: 4/169 .
[15] شرح المقاصد: 5/255.
[16] الاقتصاد في الاعتقاد: 151 .
[17] الأحكام السلطانية، للماوردي: 6 .
[18] الأحكام السلطانية، للفراء:20، الفصل:4/89، مآثر الإنافة: 1/37، وانظر مقدمة ابن خلدون الفصل: 26 / 242 ـ 245.
[19] الأحكام السلطانية للفراء: 20.
[20] المصدر السابق الفصل: 4/89.
[21] الأحكام السلطانية، المقدمة: 243 .
[22] صحيح البخاري: الفتن باب 20، ح 6695 .
[23] المصدر السابق، الفتن باب 3 ح 6649، فتح الباري بشرح صحيح البخاري:13 / 7 ـ 8 .
[24] تطهير الجنان واللسان: 30 .
[25] صحيح مسلم، كتاب الفضائل، ح 1.
[26] رأس الحسين، ابن تيمية: 200 ـ 201، مطبوع مع استشهاد الحسين للطبري.
[27] نظرية الإمامة، الدكتور أحمد محمود صبحي: 26 .
[28] وهو الذي ارتدّ مشركاً في عهد الرسول، فهدر الرسول دمه يوم فتح مكّة، وأمر بقتله ولو وجد تحت أستار الكعبة! راجع ترجمته في: الاستيعاب، واُسد الغابة، والإصابة.
[29] أي ارسالهم الى أطراف البلد بحجّة حماية الحدود، ومنعهم عن العودة الى أهليهم.
[30] تاريخ الطبري، احداث سنة 34: 4 / 333 ـ 335 .
[31] الزيدية: 35 ـ 37. وانظر أيضاً: محمّد عبدالكريم عتّوم، النظرية السياسية المعاصرة للشيعة الإمامية الاثني عشرية: 52 فقد انتهى الى النتيجة ذاتها.
[32] تفسير مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي: 2 / 83 .
[33] تفسير المنار: 5/187 ـ 188.
[34] الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي لعبدالرحمن عبدالخالق: 113 ـ 114.
[35] آلاء الرحمن: 364. وسائر علماء الشيعة على هذا المنوال أو قريب منه كالفيض الكاشاني في تفسير الصافي: 1/310 والسيد شبر في تفسيره: 165 .
[36] الأحزاب: 36.
[37] معالم المدرستين: 1/576. وولاية الأمر للشيخ الآصفي : 167.
[38] مآثر الانافة: 1/52، الأحكام السلطانية، الماوردي: 10، والأحكام السلطانية، للفراء: 25، 26 .
[39] تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي، صائب عبدالحميد: 259 ـ 260 .
[40] تاريخ الطبري: 3/218 ـ 219 . وانظر دراسة مصادر الحديث في موسوعة التاريخ الإسلامي : 1/407 ـ 427 . وفي كتاب ما نزل من القرآن في علي لأبي نعيم ـ جمع الشيخ المحمودي: 155 وتفسير الخازن: 3/371.
[41] المائدة: 55.
[42] الكشاف للزمخشري: 1/649.
[43] سنن الترمذي: 5/591 باب فضائل الإمام علي(عليه السلام) والتاج الجامع للاُصول: 3/335.
[44] سنن الترمذي: 5/594 ـ باب فضائل الإمام علي. والتاج الجامع للاُصول: 3/335.
[45] مسنـد الإمـام أحمد بن حنبل: 1/3. وسنن الترمذي: 5/594. وتفسير الكشاف، للزمخشري: 2/243.
[46] الكشاف: 2/243.
[47] المائدة: 67، قال الواحدي في أسباب النزول: 135، نزلت في غدير خم.
[48] صحيح مسلم: 4/1874.
[49] سنن الترمذي: 5/591. والتاج الجامع للاُصول: 3/333، أخرجه عن زيد بن أرقم عن النبي(صلى الله عليه وآله).
[50] مسند الإمام أحمد بن حنبل: 4/281، 368، وسنن ابن ماجة، المقدمة1 باب 11. وتفسير ابن كثير: 1/22. والبداية والنهاية، لابن كثير أخرجه بعدة طرق: 7/360 ـ 361.
[51] التاج الجامع للاُصول: 3/337، رواه مستقلاً «رحم الله عليّاً اللّهم أدر الحق معه حيث دار..».
[52] المائدة: 3.
[53] الاتقان، للسيوطي: 1/75 في رواية نزول الآية يوم الغدير وأنه يوم الثامن عشر من ذي الحجة. وأسباب النزول، للواحدي: 135.
[54] مناقب أمير المؤمنين، للحافظ محمد بن سليمان الكوفي القاضي: 1/119.
[55] مسند الإمام أحمد بن حنبل:4/281، وقد أشهد عليّ جمعاً من الناس، فشهد له ثلاثون أنهم سمعوا هذا الحديث من رسول الله. والبداية والنهاية، لابن كثير: 7/360.
[56] راجع قصة يوم الدار وانذار العشيرة وموقف الرسول في غزوة تبوك وسورة براءة وحجة الوداع ورزية يوم الخميس حين أراد النبي(صلى الله عليه وآله) ان يكتب الوصية قبيل وفاته، في صحيح البخاري وغيره من الصحاح والمسانيد.
[57] تاريخ الطبري : 3/292.
[58] نشأة التشيّع والشيعة : 63 و 64.